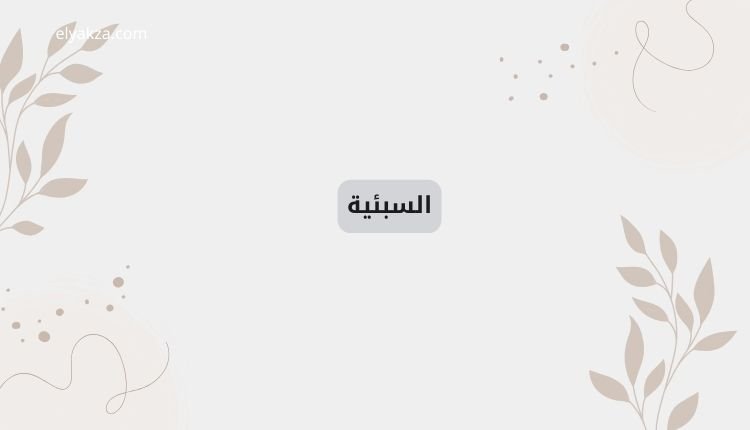لطالما كانت صفحات التاريخ الإسلامي غنية بالأحداث الجسام، والصراعات الفكرية والسياسية التي شكلت ملامح الحضارة الإسلامية. ومن بين الفئات التي أثارت جدلاً واسعاً وتركت بصماتها العميقة في تلك الحقب، تبرز “السبئية”. فمن هم السبئية؟ وما هي معتقداتهم؟ وكيف تفاعلت الدول الإسلامية، لا سيما الدولة الأُموية، مع هذا التيار الذي وُصف بالباطنية والمؤامرة؟ يغوص هذا المقال في كواليس تاريخ السبئية ليكشف عن تأثيرهم الممتد من حروب دير الجماجم إلى تأسيس مدن، ومن عقائد سرية إلى تحالفات أثرت في مسار الخلافة.
قائمة المحتويات
جذور السبئية وتأسيس مدينة قم
تعود بدايات ظهور ما يُعرف بالسبئية، وفقاً للعديد من المصادر التاريخية، إلى فترة تمردات واضطرابات في العراق، تخللها صراعات دموية مع الدولة الأموية. كان القائد ابن الأشعث، المنحدر من قبائل قحطان اليمنية، شخصية محورية في هذه الأحداث، حيث تمرد على الدولة الأموية طمعاً في الخلافة، وخاض معارك دامية ضد الحجاج بن يوسف والي العراق. انتهت هذه المعارك بهزيمة ابن الأشعث وفرار فلوله.
تذكر الروايات أن هذه الفلول المنهزمة، والتي وُصفت بأنها “سبئية”، هربت إلى مدينة قم الإيرانية، والتي كانت آنذاك مدينة جبلية يقطنها الزرادشتيون بشكل كبير. هناك، قامت هذه الفلول بتأسيس مركز للتشيع، غيّر وجه المدينة لاحقاً. كان وصول الأشعريين، وهم قبيلة يمنية، إلى قم عاملاً حاسماً في انتشار الإسلام والمعتقدات الشيعية فيها.
ورغم أن بعض الأشعريين في الكوفة كانوا من المسلمين السنة، إلا أن الذين استقروا في قم كانوا، وفقاً للمؤرخين الشيعة أنفسهم، من أشد المناصرين للتشيع وعملوا على نشره، حتى أصبحت قم في نهاية المطاف عاصمة للتشيع في العالم. هذا التحول يعكس كيف يمكن للحركات المنهزمة سياسياً أن تجد لها ملاذاً وموطئ قدم جديداً لتؤسس منه نفوذاً دينياً وفكرياً عميقاً.
الحجاج بن يوسف ودير الجماجم: مواجهة الفتنة السبئية
كان الحجاج بن يوسف، والي العراق، في طليعة القادة الأمويين الذين واجهوا تمرد ابن الأشعث وفلوله، والتي وصفها الأستاذ صابر مشهور في حلقة له على اليوتيوب بالسبئية. دارت بين الطرفين معارك طاحنة عرفت باسم “معارك دير الجماجم” على مدى ثلاث سنوات. هذه المعارك لم تكن مجرد صراع عسكري على السلطة، بل كانت، مواجهة بين الدولة الأموية التي رآها البعض معياراً للحق، وبين فئة وُصفت بالباطنية والجهلة التي كانت تسعى لزعزعة استقرار الدولة وتغيير أسس الدين.
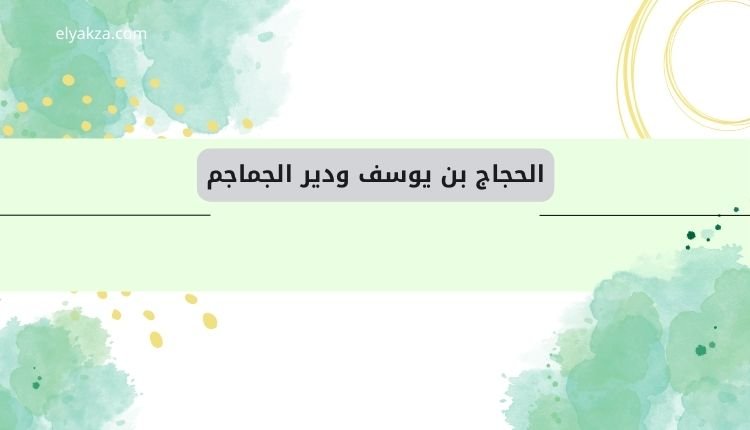
يُظهر الأستاذ صابر مشهور في الفيديو المشار له منظوراً قوياً يدافع عن الحجاج والدولة الأموية، معتبراً إياهما صمام الأمان للإسلام. ويذهب إلى حد القول بأنه لو هُزم الحجاج وقتل في هذه المعارك، لكان الإسلام قد اختفى، ولأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته والصحابة عرضة للطعن والسب كما يحدث اليوم في بعض الأماكن التي يسيطر عليها من يصفهم بالباطنية.
ويسرد الأستاذ صابر شهادات تاريخية، منها ما ذكره المؤرخ العباسي خليفة بن خياط عن 81 معركة دارت في دير الجماجم، مما يدل على ضراوة القتال وحجم التضحيات. كما يستشهد بشعر الفرزدق الذي يمدح جيش الحجاج ويشبهه بجيش المسلمين في بدر، ويصف من قاتل الحجاج بأنهم ناكثو عهد وسبئية. هذه النظرة تضع الحجاج في مصاف المدافعين عن العقيدة الصحيحة ضد من يصفهم بالخارجين عليها.
فكر السبئية ومعتقداتهم: من التشيع السياسي إلى الباطنية
تطور الفكر السبئي من مجرد دعم سياسي للإمام علي رضي الله عنه إلى تبني عقائد غالية وباطلة. يشدد الأستاذ صابر مشهور على أن السبئية ليست مجرد تشيع سياسي يؤيد علي، بل هو تيار يؤدي في النهاية إلى “تشيع باطني” يستبيح دماء المسلمين ويطعن في الصحابة وزوجات النبي. يبدأ هذا المسار، بالإدعاء بأن علي “على حق” وأن من عارضه على باطل، ثم يتطور إلى اتهام الصحابة بالكفر وتحريف القرآن.
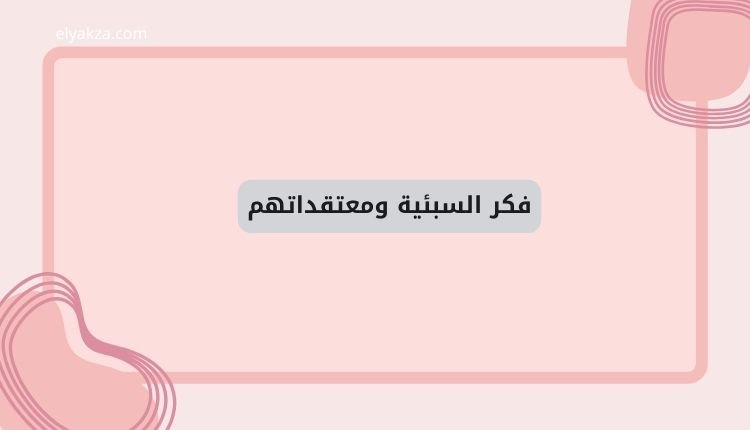
يبرز الأستاذ صابر في الفيديو شخصية عبد الله بن سبأ كأول شيعي سياسي، ثم يشير إلى أن علي بن أبي طالب نفسه لم يقل قط إنه على حق مطلق في صراعاته، بل كان يرى ما فعله اجتهاداً. لكن السبئية من جانبهم، اختلقوا أحاديث نبوية لدعم موقفهم، مثل حديث “عمار تقتله الفئة الباغية”، مما أدى إلى تحويل الأحاديث الموضوعة إلى جزء من الدين. هذه العملية أدت إلى سيطرة الباطنية على التشيع السياسي، وظهرت عقائد غالية مثل القول بأن علي إله (تعالى الله عن ذلك)، أو أن هناك قرآناً سرياً (كتم تسعة أعشار الوحي)، أو الإيمان بالرجعة وتناسخ الأرواح. هذه المعتقدات، أصبحت لاحقاً أساساً لفرق مثل الدروز والإسماعيلية والنصيرية.
أبو هاشم والتحالفات السرية: تأسيس الدولة العباسية
بعد هزيمة السبئية في دير الجماجم، لم ينته نشاطهم، بل تحولوا إلى تنظيم سري بقيادة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب، حفيد الإمام علي. يُتهم أبو هاشم بإحداث فتنة كبيرة وزعمه أنه يرث الرسول وأهل بيته، وتحالفه مع السبئية ليصبح إمامهم وشيخهم. ويرجح الأستاذ صابر أنه إما اعتنق أفكارهم الغالية أو تحالف مع “الشيطان” طمعاً في الخلافة، حتى لو كان ذلك على حساب هدم الإسلام وتكفير الصحابة.
الأخطر في هذا السياق، هو ما يربطه الأستاذ صابر بين هذا التنظيم السري وتأسيس الدولة العباسية. فبعد وفاة أبي هاشم، وبما أنه لم يكن له أبناء ذكور، سلم قيادة التنظيم السري إلى ابن عمه محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، الذي كان جده عم الرسول. هذا الأخير هو من سيُقتل لاحقاً على يد الأمويين، وسيكون ابنه أبو العباس السفاح أول خليفة عباسي. هذا التحول يشير إلى أن الدولة العباسية، بحسب هذه الرواية، نشأت كدولة سبئية في جذورها، متأمرة على الدولة الأموية من خلال تحالفات سرية مع من يصفهم الأستاذ صابر بـ “أسوأ فئة من البشر”. هذا المنظور يقدم قراءة مثيرة للجدل حول أصول الخلافة العباسية وعلاقتها بالحركات السرية آنذاك.
“قد يهمك: تاريخ الدول والخلافات الإسلامية الكبرى“
سياسة الدولة الأموية تجاه السبئية: بين المواجهة والتغاضي
تظهر الدولة الأموية في الفيديو المشار له وكأنها كانت تتخذ موقفاً متناقضاً تجاه السبئية، يتراوح بين المواجهة الشرسة والتغاضي عن بعض الأنشطة. فمن جهة، قاد الحجاج معارك ضارية ضد فلول ابن الأشعث الموصوفين بالسبئية، وفيها تم سحق تمرداتهم العسكرية. ومن جهة أخرى، يذكر الأستاذ صابر أن الخليفة الوليد بن عبد الملك، عندما وشى به زيد بن الحسن، ابن عم أبي هاشم، ألقى القبض على أبي هاشم وحبسه، لكنه أطلق سراحه لاحقاً بوساطة من علي زين العابدين. هذا يدل على أن الدولة الأموية لم تكن دائماً تلجأ إلى السيف مباشرة، بل كانت قد تتخذ إجراءات فكرية ودبلوماسية.
من الإجراءات الفكرية، قيام الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أخو أبي هاشم، بكتابة “رسالة الإرجاء” التي تتلى في المساجد. هذه الرسالة دعت إلى التبرؤ من السبئية وتأكيد سلامة القرآن، وإرجاء الحكم في الخلافات بين الصحابة (مثل عثمان وعلي) إلى الله. هذا يعكس محاولة أموية لاحتواء الفكر السبئي من الداخل عبر رجال من أهل البيت أنفسهم.
أما التغاضي، فيتجلى في قصة الشاعر كثير عزة، الذي كان يدعو لعقائد سبئية غالية (مثل تعدد الأنبياء وتناسخ الأرواح) ويطعن في شرعية الأمويين. ومع ذلك، كان الخليفة عبد الملك بن مروان يكافئه ويغض الطرف عن دعوته، إما لكون نشاطه سلمياً أو لحاجته لدعمه الإعلامي والشعري، أو لظنه أنه “مجنون”، مما يبرز تعقيد العلاقة بين السلطة الحاكمة وتلك التيارات الفكرية.
“اطلع على: تاريخ الدولة الأموية“
شخصيات سبئية بارزة وتأثيرها
لم تكن السبئية مجرد تيار فكري، بل كانت تضمنت شخصيات فاعلة أثرت في انتشار معتقداتهم وتوجيه نشاطاتهم. من أبرز هذه الشخصيات، بالإضافة إلى أبي هاشم:
- كثير عزة:
الشاعر المعروف الذي وصفه النص بأنه “شاعر السبئية”. كان يروج لعقائد غالية ستصبح أساسية لدى فرق مثل الدروز والإسماعيلية والنصيرية. ورغم أن نشاطه كان شعرياً وفكرياً لا عسكرياً، إلا أن تأثيره كان كبيراً في نشر الأفكار السبئية، مستفيداً من تغاضي الأمويين عنه. تظهر الروايات حوارات طريفة بينه وبين الخلفاء الأمويين، تبرز ذكاء عبد الملك في التعامل معه، وتكشف عن معتقداته الغريبة حول تعدد الأنبياء وتناسخ الأرواح والرجعة.
- خندق الأسدي:
شاعر آخر، وصديق كثير عزة، وصفه * بأنه كان من “الخشابية” (أي السبئية) ويقول بالرجعة. قُتل عند الكعبة بعد أن سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وتبرأ منهما علناً في موسم الحج، مما يعكس مدى غلوه وجرأته. يُنسب إليه أنه هو من “أدخل كثيراً في مذهب الخشبية”، مما يشير إلى دوره القيادي في الدعوة لهذه الأفكار.
هذه الشخصيات، وغيرها، لعبت دوراً محورياً في صياغة الفكر السبئي ونشره، وتحويله من مجرد انتماء سياسي إلى منظومة عقائدية كاملة، أثرت لاحقاً في تشكيل العديد من الفرق الباطنية في الإسلام.
“قد يهمك: الكتب الأموية“
السبئية: الخاتمة
تُظهر دراسة السبئية كيف يمكن للحركات الهامشية أو المنهزمة عسكرياً أن تتحول إلى قوة فكرية وتنظيمية تحت الأرض، لتؤثر بعمق في مجرى التاريخ. لقد كانت السبئية، بوصفها تياراً يجمع بين التشيع السياسي والمعتقدات الغالية والباطنية، تحدياً مستمراً للدول الإسلامية، لا سيما الأموية. ورغم الجهود المبذولة لمواجهتها، سواء بالسيف في معارك دير الجماجم، أو بالفكر من خلال “رسالة الإرجاء”، أو حتى بالتغاضي تكتيكياً عن بعض رموزها، فإنها استمرت في التطور والتأثير.
تُقدم هذه الرواية التاريخية للسبئية نظرة فريدة حول تعقيدات الصراعات الداخلية في تاريخ الإسلام، وكيف تشابكت الأبعاد السياسية والدينية والفكرية لتشكل نسيجاً غنياً بالأحداث والشخصيات التي لا يزال صداها يتردد في واقعنا المعاصر.
يعد كمال علي كاتبًا متخصصًا في الشؤون الإسلامية، حيث يقدم محتوى مميزًا يجمع بين الأسلوب السهل والطرح العميق. يكتب عن العقيدة، الفقه، السيرة النبوية، والتربية الإسلامية، مع الحرص على تبسيط المفاهيم الدينية لتكون في متناول الجميع.
يحرص كمال على أن تكون مقالاته مصدرًا للوعي الديني الصحيح، بعيدًا عن التعقيد أو الغموض، مع التركيز على إبراز سماحة الإسلام ووسطيته. كما يربط بين التعاليم الإسلامية والحياة اليومية ليجعل القارئ أكثر قدرة على تطبيق القيم الدينية في واقعه المعاصر.
إلى جانب ذلك، يولي اهتمامًا بمواضيع الشباب والأسرة والتحديات التي يواجهها المسلم المعاصر، مما يجعل كتاباته شاملة ومؤثرة.