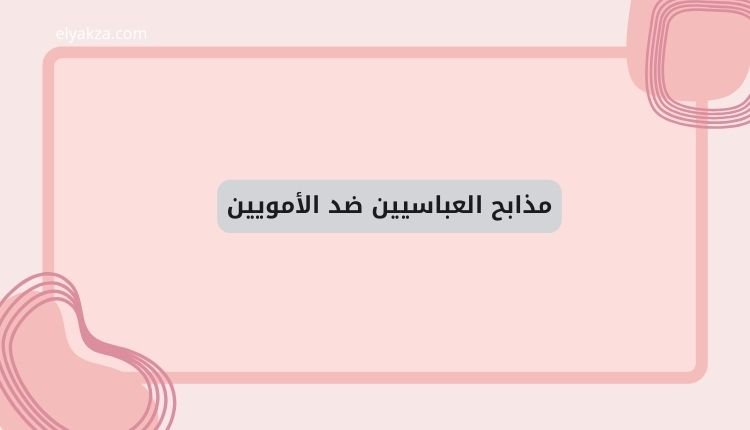تُعدّ فترة انتقال الخلافة من الأمويين إلى العباسيين من أكثر الفصول العنيفة وإثارةً للجدل في التاريخ الإسلامي المبكّر. لم تكن المسألة مجرد تغيير سياسي أو تبدّل حكم، بل حملت معها موجة من العنف المنظّم تجاه عائلةٍ كاملة تمثل السلالة الحاكمة السابقة. العنوان الذي اختُير لهذه الدراسة — مذابح العباسيين ضد الأمويين — يعكس حقيقة أن ما جرى بعد نصر العباسيين لم يكن صراعًا عسكريًا فحسب، بل سياسةً ممنهجةً لاستئصال أثر البيت الأموي، ممارساتٍ شملت القتل، النبش في القبور، الاعتداء على النساء، والحملات الانتقامية في أماكن متفرقة من العالم الإسلامي آنذاك.
قائمة المحتويات
في هذه المقالة سأعرض سردًا مترابطًا للأحداث من يوم معركة الزاب وصولًا إلى تطورات ما بعد القضاء على مروان بن محمد، مع تحليل لشخصيات رئيسية مثل أبو العباس السفاح، عبد الله بن علي، أبو مسلم الخراساني، وصالح بن علي. كذلك سنبحث أسباب العنف، أساليبه، نتائجها المباشرة والبعيدة المدى، واستمرار بقايا الأمويين في الأندلس وأماكن أخرى. الهدف تقديم مادة مفصّلة تخدم الباحث العام والقارئ المهتم بالتاريخ الإسلامي السياسي والاجتماعي، مع مراعاة الأمانة التاريخية وتحليل الدوافع والخلفيات.
خلفية سريعة: من أين بدأت الحكاية؟
بعد انتفاضة طويلة الدوافع في خراسان وغيرها، استطاع العباسيون حشد تأييد واسع ضد الأمويين، وبلغ ذروة الصراع في عام 132 هـ حين انتصر العباسيون في معركة حاسمة — ما يُشار إليه في الروايات بـ «معركة الزاب» — الأمر الذي مهد الطريق إلى سقوط دمشق العاصمة الأموية. مع سقوط الموقع الرمزي للعاصمة، لم يعد الهدف مجرد الإطاحة بالحكم بل تنفيذ مشروع تأسيسي جديد للخلافة العباسية، وهذا ما غيّر قواعد اللعبة: لم يعد الحديث دبلوماسياً أو انتقالًا على قدرٍ من النزاع المحدود، بل نابعت سياسة جديدة قائمة على الإقصاء الجذري للخصم السياسي.
شخصية مركزية: أبو العباس السفاح ودوره في تصعيد العنف
أبو العباس السفاح تبوأ منصب الخليفة العباسي الأول ومثّل التحول القاطعي عن حكم بني أمية. عُرف عنه قوله عند المبايعة: «الله رد علينا حقنا وختم بنا كما افتتح بنا. فاستعد فأنا السفاح المبيح والثائر المبير.» هذه العبارة لا تعبّر فقط عن استلام سُلطة، بل تحمل دلالة النداء إلى الثورة والقصاص. التصرفات التي أثبتتها المصادر التاريخية تُظهر سفاحًا وعن رجاله ميلًا إلى التعامل الحاسم مع بقايا الأسرة الأموية، وغالبًا بتفويض من قياداتٍ ميدانية أو طبقةٍ من الانضباط القاسي.
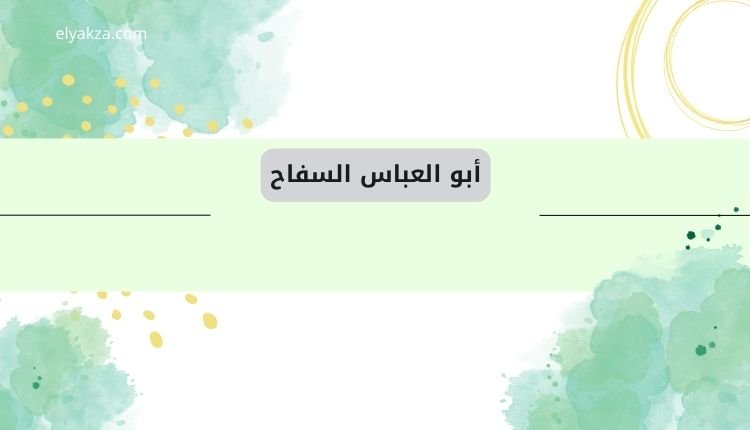
لكن بفحص أوسع، يجب التمييز بين دور السفاح كقائد سياسي يطالب بالاستقرار بعد الثورة وبين دوره أو تفويضه بأعمال انتقامية واسعة النطاق. في كثير من الروايات التاريخية، نرى أن عمليات الترحيل، الملاحقة، وحتى عمليات الإعدام النابية نفذها قادة ميدانيون مثل عبد الله بن علي أو قادة خرسانيون تحت ذريعة أمن الدولة وإطفاء نار الفتنة.
مشاهد العنف في دمشق: اقتحامٌ، نبشٌ، وحملة إبادة
حين وطأت جيوش عبد الله بن علي دمشق، تذكر الروايات أن دخولها تمارسه القوات بالسيف وبطريقة منظمة: حصارٌ ثم اقتحام، واستهدافٌ ممنهج لأشخاص محدّدين من بني أمية وآلائهم. تذكر المصادر حدوث ما يشبه «مقاتل عظمى» أُقيمت فيها مجازر، قضت خلال ساعاتٍ محدودة على مئات وربما آلاف من الناجين أو مؤيدي النظام السابق. كما وردت روايات صادمة عن نبش قبور خلفاء أمويين كبار مثل معاوية وعبد الملك وغيرهم، وتعمد التعذيب والذّكر العلني للمهانة، وإحراق الجثث ونثر الرماد في الهواء — سلوك يعدّ من أقسى علامات العدوان الرمزي والاجتماعي.
هذه الصور لم تكن تهدف بالضرورة إلى تحقيق مكاسبٍ عسكرية؛ بل تبدو رسائل رادعة لقطع الأمل بالعودة وإسكات أي ذكرٍ رمزي أو شعبي للبيت الأموي. في الوقت نفسه، حملت هذه الأعمال طابعًا شخصيًا مكثفًا، إذ أن بعض الروايات تشير إلى رغبةٍ في الانتقام الفردي أو استعراض القوة من قِبَل قادة الحملة.
عبد الله بن علي: القائد الميداني وتوسيع دائرة القمع
عبد الله بن علي، عم الخليفة السفاح، لعب دورًا مركزيًا في العمليات الميدانية، وبرز كمنفّذٍ صارم لأوامر التمحيص والإبادة في المناطق الواقعة تحت سيطرة العباسيين. عندما دخل دمشق «دخلها بالسيف»، إذ تُشير الروايات إلى عمليات قنص ممنهجة ضد الأمويين وذويهم، وعمليات اعتقال وإعدامٍ جماعي. تشمل الأعمال المذكورة أيضاً اعتداءات على النساء، استخدام التعذيب، وإقامة «مذابح ميدانية» استمرت لساعات، مع توسّع نطاق العقاب ليشمل القبور والأموات أحيانًا.
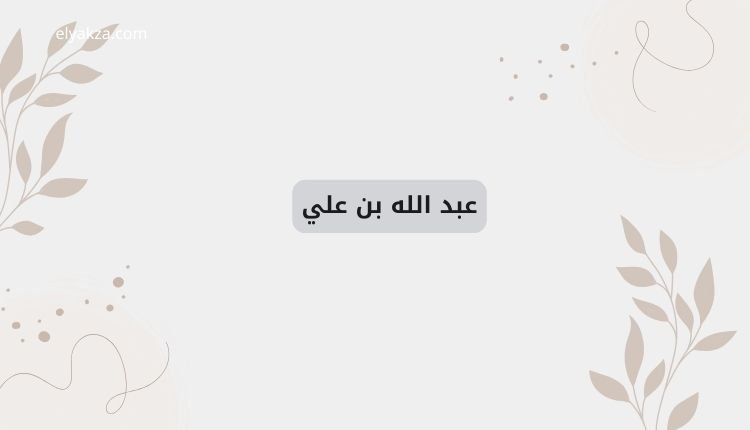
هذا المستوى من القسوة لم يكن فقط للحصول على ثأر؛ بل كان أيضًا تكتيكًا لقطع حلقات الدعم الاجتماعي والسياسي التي كانت قد تبقي للأمويين جذورًا في المجتمع — فسحق رموز العائلة وإظهار قدرتك على معاقبة حتى الأموات يُعدّ رسالة قُطرية لمن يفكر بالمقاومة.
من استُهدف ولماذا؟ تحليل للفئات المتأثرة
المستهدفون شملوا عدة فئات:
- أفراد الأسرة الأموية من خلفاء وملوكٍ ووجهاء.
- معاوني النظام الأموي من مؤسساتٍ محلية ومسؤولين أقل رتبة.
- عائلات وأتباع محليين لم يكونوا بالضرورة فاعلين سياسيًا، لكن نسبهم الأموي جعلهم عرضة للعقاب.
- بقية المهاجرين والناجين الذين تجمّعوا ظنًا بالأمان ثم ألقي القبض عليهم.
الدوافع متعددة: الانتقام، القضاء على مصادر الشرعية السابقة، إحالة التحول إلى بُعدٍ رمزيٍّ نهائي، وإرساء سلطة جديدة لا تحتمل بقاء أي بُقايا للمنافس السابق. كما لعبت عوامل اجتماعية ونفسية دورًا — غضبٍ طبقي، رغبة في الانتقام التاريخي، ونفاذ أعصاب القيادات بعد سنوات من المقاومة والقتال.
نبش القبور والاعتداء على الموتى: رمزية استثنائية للعقاب
من أكثر الأحداث إيلامًا ورمزية كانت نبش قبور خلفاء أمويين و»الانتقام منهم بعد الموت» — إذ ذكر التاريخ أن جثثًا أو رفاتًا لوجوهٍ أمويّة كُشفت، وضربت بالسياط، وصلبت، ثم أُحرقت أو نُثر رمادها. هذه الأفعال تحمل دلالة مزدوجة: أولًا، رغبة في تكليل الانتقام بشكل كامل غير مرحّب به من أي تقبل مجتمعي؛ ثانيًا، محاولة لكسر القداسة الرمزية المسجّلة لدى أنصار البيت الأموي عبر استفزاز انفعالاتهم وطمس مقامات تاريخية. أفعال كهذه تزيد الكراهية بين الجماعات وتترك أثرًا نفسيًا وثقافيًا عميقًا يمتد لأجيال.
استهداف النساء والأسر: بعد إنساني مظلم
روى بعض المؤرخين قصصًا عن إرسال نساء من بيت أموي إلى الصحراء سيرًا على الأقدام، مُجَرَّدات من الحلي، مُهانات، ثم يُقتلّن — أو يتم احتجازهن كرهائن. مثل هذه الممارسات تظهر قدرة الحروب الأهلية على اختراق كل حدود الإنسانية، وتبيّن كيف يتم استهداف النسيج الاجتماعي والعائلي بشكل يهدف لخلق هزيمة معنوية لا تقل وحشةً عن الهزيمة العسكرية.
المطاردة خارج الشام: تتبّع الأمويين في الأقطار
لم تقتصر الملاحقات على الشام؛ فقد امتدت إلى العراق، البصرة، مكة، المدينة، وغيرها. اتسعت دوائر المطاردة لتشمل كل من يُعتقد أنه من بني أمية، بما في ذلك ذوو مراكز متواضعة أو مجرد نسبٍ يؤدي إلى الاستهداف. الكثير نجح في الاختفاء أو التنكر، لكن آخرين لم يسلموا، مثل من ضُربوا حتى الموت أو أُلقيَ بهم للكلاب على طرقٍ عزلاء. الآثار المجتمعية لذلك كانت هجرة جماعية، تشظٍّ اجتماعي، وتسيّد الخوف على فترات طويلة.
الناجون: عبد الرحمن الداخل وبناء إمارة أندلسية
رغم محاولات الإبادة، نجا بعض أفراد الأسرة الأموية. أبرزهم عبد الرحمن بن معاوية المعروف بـ«عبد الرحمن الداخل» أو «صقر قريش»، الذي فرَّ إلى الأندلس وأسس هناك إمارة أموية في عام 138 هـ، عاشت مستقلةً عن الخلافة العباسية لقرونٍ متتالية، وشكّلت استمرارًا خطيًا للوجود السياسي الأموي في غرب العالم الإسلامي. نجاح عبد الرحمن في إعادة بناء سلطة أمويّة في الأندلس يبيّن أن سياسة الإبادة لم تنجح في محو الأثر تمامًا؛ بل حفزت اتجاهًا جديدًا للنشاط الأموي في المحيط الأطلسي والمتوسط.
دوافع العباسيين: أمن أم انتقام أم بناء دولة؟
لفهم هذه الحوادث لا بد من التمييز بين دوافعَ متداخلة:
- المنطق الأمني والسياسي: القضاء على رموز يدعمها قسم كبير من المجتمع كان يُرى كضرورة لضمان عدم تجدد حركات المضادة وإعاقة تأسيس نظام عباسي مستقر.
- المنطق الانتقامي: سنوات من القهر والعداء التاريخي بين بيتي المروانية والعباسية أدّت إلى رغبةٍ شخصية وجماعية في الثأر.
- المنطق الرمزي: محو حضورٍ سياسي وثقافي للأمويين كان وسيلةً لتثبيت رواية سياسية جديدة ولإعادة تشكيل الذاكرة الجماعية.
هذه المضامين لا تتعارض؛ بل غالبًا ما تداخلت وثبَّتت بعضها البعض في اتخاذ قراراتٍ قاسية أفرزت نتائج إنسانية وخيمة.
“قد يهمك: الكتب الأموية“
الأثر الطويل المدى: سياسية، اجتماعية وثقافية
الأحداث التي وقعت بعد سقوط الدولة الأموية أسفرت عن آثار عميقة:
- سياسيًا: ترسيخ سلطة العباسيين لكن مع تبعات: الولاءات القبلية والمحلية أصبحت أكثر هشاشة، وبرزت مآخذ على شرعية العباسيين لدى بعض الجماعات.
- اجتماعيًا: هجرة ونفي ونفور الطبقات المتضررة، خلق ندوب بين قبائل وعوائل استمر تأثيرها قرونًا.
- ثقافيًا وذاكريًا: محو أو إخفاء بعض الرموز الأموية داخليًا دفع لتكوّن سرديات موازية؛ الأندلس كمشروع أموي بديل أصبح شهادةً على فشل محاولات الإبادة الشاملة.
بالإضافة لذلك، تركت المشاهد الوحشية أثرًا أخلاقيًا طويل الأمد في الذاكرة الإسلامية؛ إذ استخدمت لاحقًا كنماذجٍ للنقد أو التبرير في سياقاتٍ سياسية مختلفة.
مصادر أحادية أم تعددية؟ قراءة نقدية للمصادر التاريخية
معالجة هذا النوع من الأحداث تتطلب تعاملًا حذرًا مع المصادر: كثيرٌ من الروايات التاريخية جاءت من مصادرٍ مؤرخة بعد عقود وربما ملوَّنة برؤى الانتصار أو الهزيمة. لذا ينبغي:
- المقارنة بين مصادر مختلفة (الراوية الأمويّة، العباسية، وأحيانًا المصادر المحلية أو الاندلسية لاحقًا).
- التفريق بين الرواية الرمزية (التي تخدم خطابًا سياسياً) والوقائع الميدانية المؤكدة.
- الانتباه إلى أن بعض السرديات قد تزيد في وصف الوحشية كأداةٍ لتأكيد شرعية الطرف المنتصر أو لتأجيج التعاطف مع الطرف المهزوم.
التحليل النقدي يساعد في فهم أي الأجزاء واقعية وأيها مبالغ فيها أو رمزية.
“قد يهمك: تاريخ الدولة الأموية“
دروس مستخلصة ونهايات أخلاقية
من هذا الملف التاريخي يمكن استخلاص عدة دروس:
- التحول السياسي قد يتحول بسهولة إلى عنفٍ مفرط إذا ما غاب الإطار القانوني والتوافقي للانتقال.
- استهداف النسب كذريعة للعقاب هو وصفة لخلق مشكلات اجتماعية طويلة المدى لا تُحل بالقوة وحدها.
- بقاء المتضررين في الذاكرة أو صعودهم في مناطق أخرى (كما فعل عبد الرحمن الداخل في الأندلس) يبرز أن الإبادة السياسية النادرة النوعية قد تفتح أبوابًا لظهور مراكز بديلة للنفوذ تشكّل تحديًا مستقبلياً.
- أهمية التعامل مع الروايات التاريخية نقدياً لتفادي الصورة المضللة عن الماضي والاستفادة منها بشكل بنّاء.
“تعرف على: تاريخ الدول والخلافات الإسلامية الكبرى“
مذابح العباسيين ضد الأمويين: الخاتمة
تُظهر دراسة مذابح العباسيين ضد الأمويين أن نهاية قدرة نظام ما ليست بالضرورة نهاية تأثيره أو استمرار أثره الثقافي والاجتماعي. السلوك الوحشي الذي رافق انتقال السلطة لم يحقق للقادة العباسيين استقرارًا أخرويًا للأبد، بل خلق ردود فعلٍ طويلة المدى أعادت تشكيل خارطة النفوذ الإسلامي—من دمشق إلى البصرة، ومن الحجاز إلى الأندلس. كما أن بروز شخصياتٍ ناجية مثل عبد الرحمن الداخل يعكس قدرة القوى المقهورة على إعادة التموضع والبقاء.
من منظور تاريخي أخلاقي وسياسي، تبقى هذه الحقبة درسًا صارخًا عن مخاطر تحويل الصراعات السياسية إلى حملات إبادة ثقافية ودموية، وعن ضرورة السعي لتسوياتٍ تحول دون الإمعان في العنف الذي يترك جراحًا بأجيالٍ قادمة. قراءة موضوعية نقدية لمثل هذه الفصول تساعدنا على فهم كيف تشكّل الذاكرة التاريخية الحالية، وتمنح مؤشرات حول كيفية التعامل مع الانتقال السياسي في سياقات مشابهة لاحقًا.
مها أحمد كاتبة ومدونة تقدم محتوى متنوعًا يجمع بين التجربة الشخصية والتحليل الموضوعي. تكتب عن قضايا اجتماعية وثقافية وفكرية بأسلوب سلس يلامس اهتمامات القارئ اليومية.
تمتاز بأسلوبها العفوي الذي يدمج بين الطابع الشخصي والتعبير الحر، مما يجعل التدوينات قريبة من القارئ وواقعية. كما تحرص على طرح أفكار جديدة ومناقشة قضايا مجتمعية بطريقة مفتوحة للنقاش.
من خلال مدوناتها، تسعى مها أحمد إلى مشاركة الأفكار والخبرات وتبادل الرؤى مع الجمهور، لتجعل من التدوين مساحة للتواصل والإلهام.